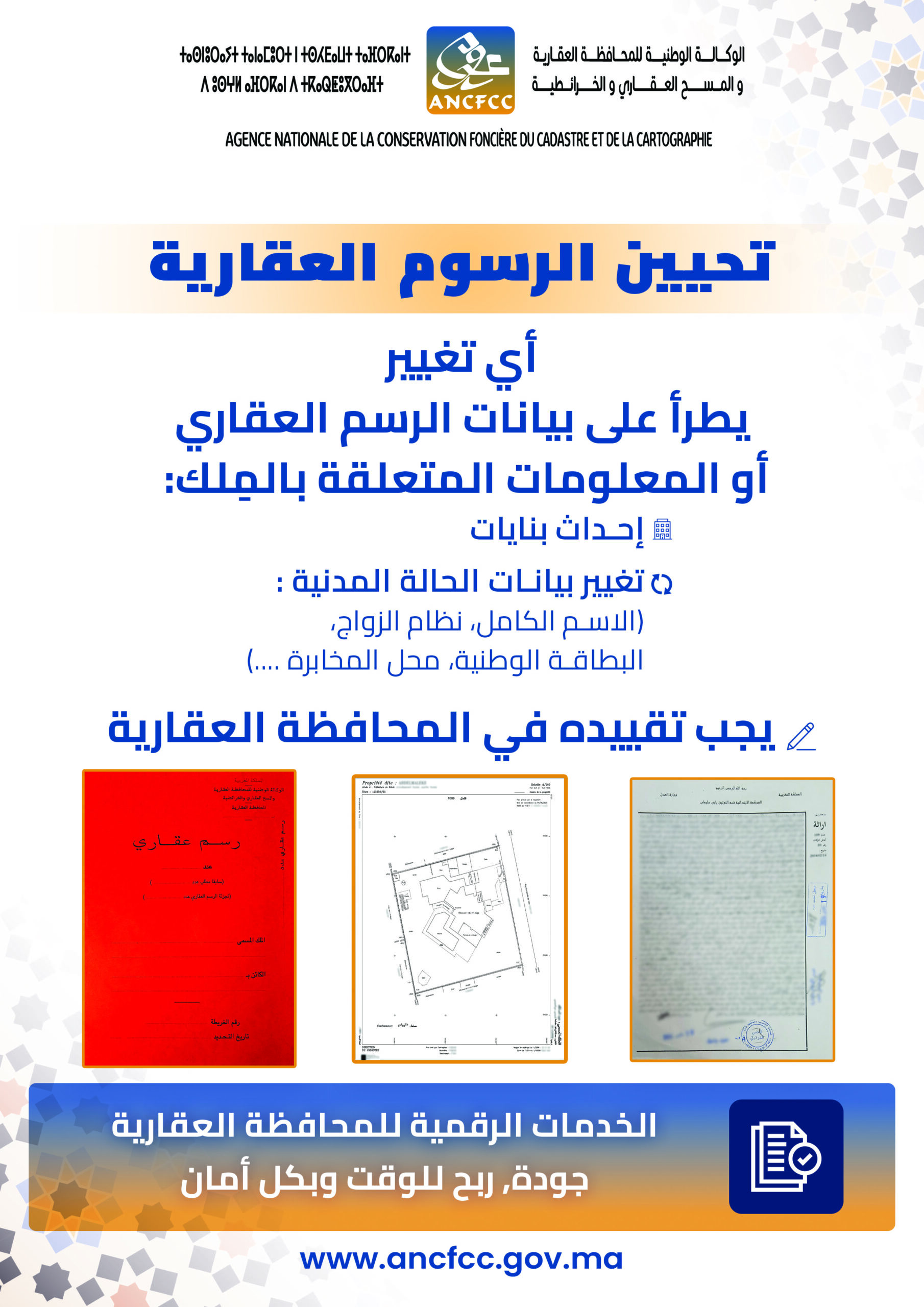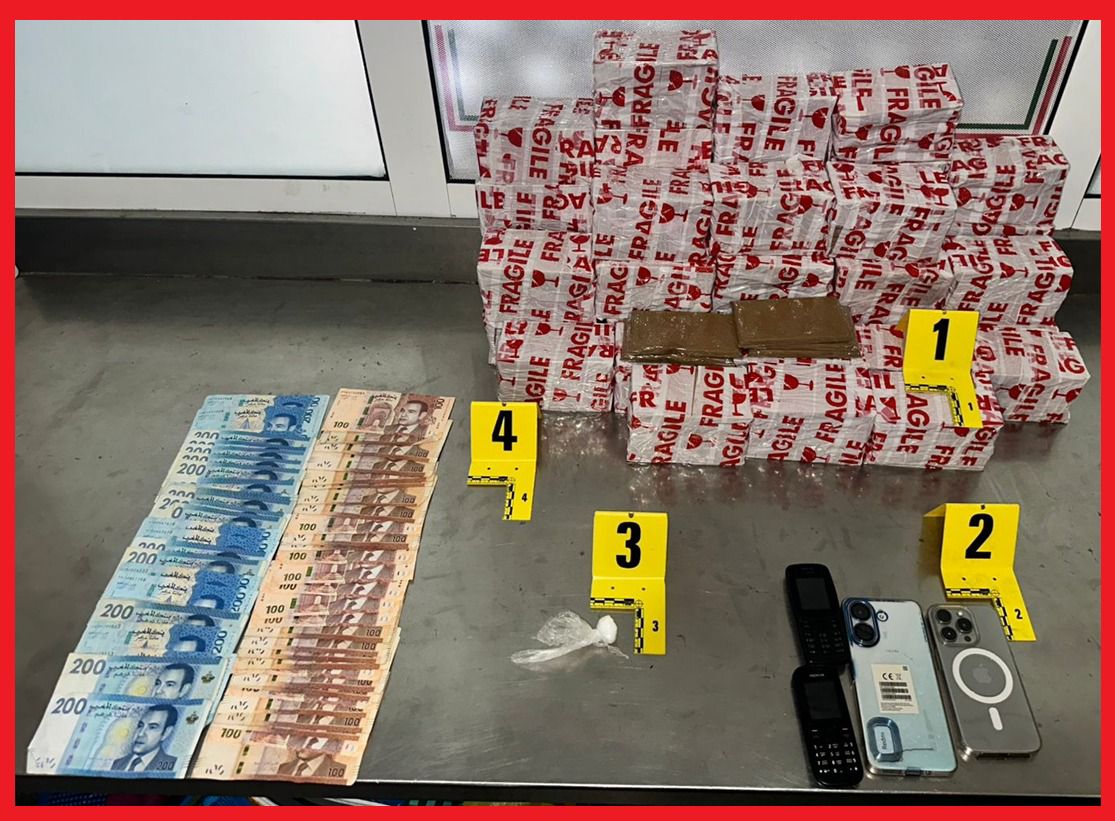اصطدام الصناعة بالفلاحة: هل عمّقت اتفاقيات التبادل الحر الفجوة بين المغرب النافع والمنسي؟

حسين العياشي
رغم ما يروَّج حول نجاح المغرب في ترسيخ موقعه كجسر اقتصادي بين أوروبا وإفريقيا بفضل توقيع أزيد من 54 اتفاقية للتبادل الحر، إلا أن هذه الطفرة تكشف وجهًا آخر أقل إشراقًا. فبينما يُقدَّم هذا الانفتاح كقصة نجاح كبرى، تتصاعد التساؤلات حول كلفته الحقيقية على الفلاحة الوطنية وعلى التوازن الاجتماعي والمجالي داخل البلاد.
فمن جهة، تحولت قطاعات صناعية كصناعة السيارات إلى نموذج مثالي يُستشهد به في كل التقارير الرسمية، حيث تضاعفت صادراتها بشكل غير مسبوق وجعلت من طنجة-ميد منصة عالمية. لكن من جهة أخرى، تبدو هذه الدينامية وكأنها صناعة انتقائية للنجاح، استفادت منها المناطق الساحلية الكبرى، فيما تُركت الفلاحة التقليدية والجهات الداخلية لتدفع ثمن منافسة غير متكافئة.
هذه الصورة، تخفي وجهًا آخر أكثر تعقيدًا، بحسب تحليل حديث صادر عن مؤسسة فريدريش ناومان. فبينما حصدت كبريات المدن الساحلية ثمار الانفتاح، بقيت مناطق واسعة من المغرب القروي على هامش هذه الدينامية. الفلاحون الصغار، الذين يمثلون حوالي 80% من اليد العاملة الزراعية، ظلوا خارج دوائر التصدير، لا لضعف الإنتاج فقط، بل بسبب غياب البنيات التحتية والولوج إلى اللوجستيك والتمويل.
ففي الوقت الذي تستفيد فيه الشركات الكبرى من شبكات التبريد والنقل البحري، تكشف بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن 12% فقط من الفلاحين الصغار بالمغرب لديهم إمكانية الوصول إلى النقل المبرد، ما يؤدي إلى خسائر بعد الحصاد قد تصل إلى 30%. كما أن ثلاثة أرباع الاستغلاليات الزراعية لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات، وهو ما يجعل تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير شبه مستحيل.
هذا التفاوت الجغرافي والهيكلي يعكس، وفق التقرير ذاته، أن الانفتاح التجاري لم يكن مصحوبًا بسياسات دامجة تضمن توزيعًا متوازنًا لعائدات التبادل الحر. فبينما ارتفع نصيب التجارة من الناتج الداخلي الخام من 59% سنة 2000 إلى 79% في 2019، ظل آلاف الفلاحين في مناطق جبلية أو شبه قاحلة مثل بني ملال-خنيفرة وأزيلال خارج مسارات التصدير، بسبب ضعف البنية التحتية وعجزهم عن المنافسة في الأسواق العالمية.
وإلى جانب هذا البعد الجغرافي، تكشف المؤسسة عن عائق آخر يتمثل في ضعف استفادة المقاولات المغربية من هذه الاتفاقيات. إذ لا تتجاوز نسبة الشركات التي تستغل فعليًا المزايا التجارية 37%، بسبب تعقيدات بيروقراطية ولوجستية تحول دون النفاذ إلى الأسواق.
في ضوء هذه الاختلالات، يدعو التقرير إلى تبسيط منظومة الحكامة التجارية وتوحيد مساطرها، مع إرساء سياسات دعم موجهة خصيصًا للفلاحين الصغار بدل الاكتفاء ببرامج دعم شاملة لا تصل إلى المستهدفين. كما يشدد على ضرورة الاستثمار في البنيات اللوجستية، خاصة النقل المبرد والمستودعات، وتوسيع شبكة التمويل لتشمل الفئات الهشة من الفلاحين.
في المحصلة، يظل سؤال التبادل الحر في المغرب مرتبطًا بمدى قدرته على تحقيق تنمية متوازنة. فبينما نجح البلد في أن يصبح لاعبًا صناعيًا إقليميًا، لم تُترجم هذه النجاحات بعد إلى تحسين أوضاع الفلاحين الصغار أو تقليص الفوارق المجالية. التحدي المطروح اليوم ليس فقط تعزيز موقع المغرب في السوق العالمية، بل ضمان أن لا يظل نصفه الآخر، القروي والمهمش، خارج معادلة الربح.