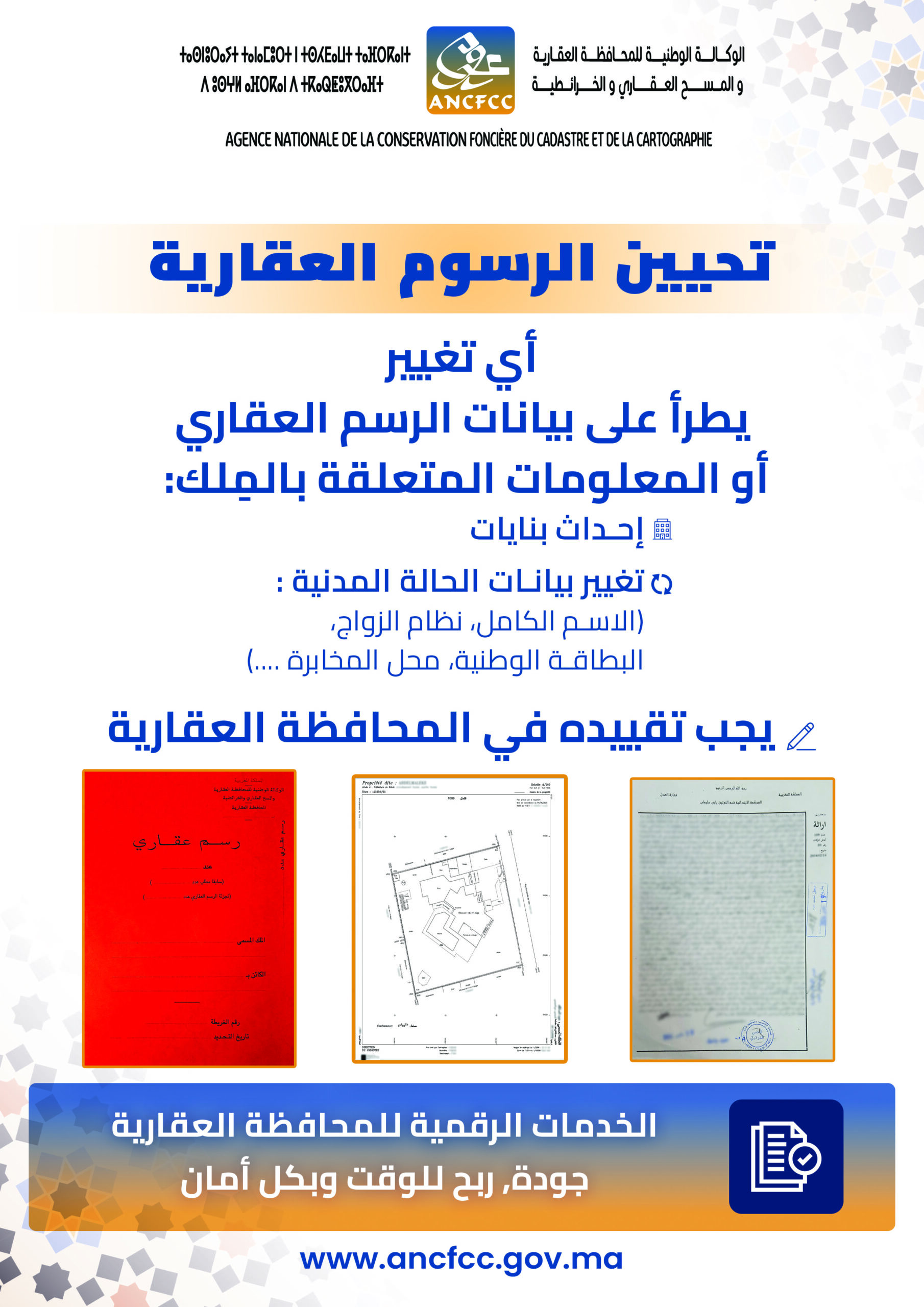لماذا تخلّت الدولة عن دعم العلف المباشر ودفعت المربّين إلى فم المضاربين؟

حسين العياشي
لا يكفي أن تُعلَن ميزانيةٌ تناهز 13 مليار درهم لتطمئن قلوب مربي الماشية، إذا كان تصميمُ السياسة يجعلهم في النهاية يقفون وجهاً لوجه أمام سوقٍ مضطرب ومضاربين يقرأون التحويلات المالية كلُقمة سائغة. فبينما تمضي الوزارة في سرد “إنجاز” التحول من الدعم العيني إلى التحويل النقدي المباشر، يكتشف “الكسّابة” أن الدولة لم تدعم العلف نفسه، بل دعمت قدرتهم المؤقتة على مطاردة سعرٍ يعلو كلما لاح في الأفق دعمٌ جديد.
تقول الوزارة إن لا تراجع في الأرقام وإن الصيغة التنازلية للدعم “غير مسبوقة”: 150 درهماً للرأس عن العشرة الأولى، و125 درهماً للأربعين الموالية، و100 درهم للخمسين التالية، مع 400 درهم للنعجة و300 للمعزة لمن يحافظ على الإناث المرقّمة إلى أبريل 2026، إضافة إلى تسبيق بـ100 درهم بين نونبر ودجنبر. لكن السؤال ليس كم تبدو الأرقام جذابة على الورق، بل كم تصمد أمام موجة الأسعار حين تترك الدولة العلف لتقلبات سوقٍ بلا كوابح. هنا يتبدّى جوهر المشكلة: التحويل النقدي، في غياب تدخلٍ ذكي في سلاسل التزوّد، يتحول من شبكة أمان إلى إشارة أسعار تدعو المضاربين إلى رفع السقف.
تؤكد الوزارة أن 90 في المئة ممن يملكون أقل من 50 رأساً سيحصلون على معدل يقارب 340 درهماً للرأس، يغطي بين 40 و60 في المئة من كلفة الأعلاف. هذا تقدير مُريح، لكنه يعجز عن التقاط الفوارق القاسية بين الأقاليم، وكلفة النقل إلى القرى البعيدة، وندرة الماء، وتذبذب العرض. إن “المعدل الوطني” يخفي وراءه مربّين يدفعون كلفة إضافية لكل كيس شعير أو علف مركّب، بينما يتلاشى أثر الدعم قبل أن يصل موسم المطر.
وتجادل الحكومة بأن إلغاء التوزيع العيني “أغلق باب الوسطاء”. غير أن إغلاق بابٍ فتح نوافذ واسعة للمضاربة في سوق مفتوحة، حيث لا تُراقَب الحلقات الوسيطة بما يكفي، ولا تُنشَر بياناتٌ آنية عن الأسعار والكميات، ولا يُفرض مخزونٌ احتياطي يُطفئ الحرائق الموسمية. من دون سياسة استباقية لضبط السوق—مراقبة هوامش الربح، تتبّع سلاسل الإمداد، تدخّل تكتيكي بآليات الشراء الجماعي أو منصات توريد عمومية—يصبح الدعم النقدي وقوداً لارتفاعٍ جديد لا شبكة إنقاذ.
العدالة التي تتباهى بها الصيغة التنازلية تصطدم بصلابة الواقع. صحيح أن المربّي الكبير يتقاضى أقل لكل رأس مع اتساع القطيع، لكن قدرة السيولة لديه تمكّنه من تخزين العلف زمن الرخص وتحمّل التأخر في صرف الدفعات. أما الصغير، فيختنق مع أول تأخير إداري أو قفزة سعرية مفاجئة. العدالة ليست معادلة نسبية فحسب؛ هي زمن وصول وكلفة إجراء وانعدام مفاجآت. حين تُصرَف الدفعة الأولى “قبل نهاية السنة” والثانية في أبريل، يكون كثيرون قد دفعوا فرق السعر مضاعفاً خلال شهور الجفاف.
ثم تأتي البيروقراطية لتضيف حاجزاً آخر: من لم يُحصِّ قطيعه بين 26 يونيو و11 غشت، أو تعذّر عليه الترقيم في الوقت المحدد، يجد نفسه خارج الشبكة. الدولة تعتبر ذلك شرط شفافية، لكنه في الأطراف يتحول إلى أداة إقصاء صامتة. كان الأجدى أن تُرافق الشرطية بديناميكية ميدانية: وحدات متنقلة للأسواق الأسبوعية، نوافذ مؤقتة في الدواوير، وخطوط مساعدة متعددة اللغات تُجيب بوضوح عن “كيف ومتى وكم”.
أما الشفافية، فتبقى وعداً مؤجّلاً. تقول الوزارة إن اللوائح محفوظة في نظام معلوماتي وتحت رقابة لجان محلية. جيد. لكن الشفافية الفعّالة تُقاس بإتاحة بيانات مجهّلة للعموم: خريطة توزيع الدعم حسب الأقاليم، آجال الأداء الفعلية، متوسطات الأسعار لحظة الصرف، ونِسَب الطعون المقبولة والمرفوضة. من دون ذلك، سيظل الاتهام بالتراجع من “400 إلى 70 درهماً” يجد تربة خصبة في فجوة المعلومات، حتى لو كانت الحسابات الرسمية تؤكد عكسه.
جوهر القضية إذن ليس حجم الميزانية، بل هندسة التدخل. لماذا لم تُدعَم الأعلاف مباشرة عبر أدوات مرِنة لا تعيد إنتاج أعطاب الماضي؟ كان ممكناً اعتماد مزيج ذكي: منصات شراء مركزية تُقلّص كلفة القنطار، قسائم رقمية تُصرف لدى مزوّدين معتمدين بهوامش رِبح مضبوطة، آلية تدخل سعري ظرفي عند بلوغ العتبة، مع إبقاء جزء من التحويل النقدي لمرونة المربّي. بهذه الهندسة، لا يُترَك الصغير في مواجهة سوقٍ يلتهم دعمه قبل أن يصل إلى المراعي.
حتى يحدث ذلك، سيبقى التحويل النقدي سياسة نصف طريق: يُعلِن الانتصار على “الوسيط التقليدي” لكنه يسلّم المربّين إلى وسيطٍ أكبر اسمه السوق غير المنضبط. والسؤال الذي يفرضه العنوان لا يزال معلقاً: لماذا تخلّت الدولة عن دعم العلف مباشرة، ودفعت المربّين إلى فم المضاربين؟ الإجابة لن تكون في رقمٍ جديد، بل في تصميمٍ جديد يُمسك بالسوق من عنقه، لا من ظله.