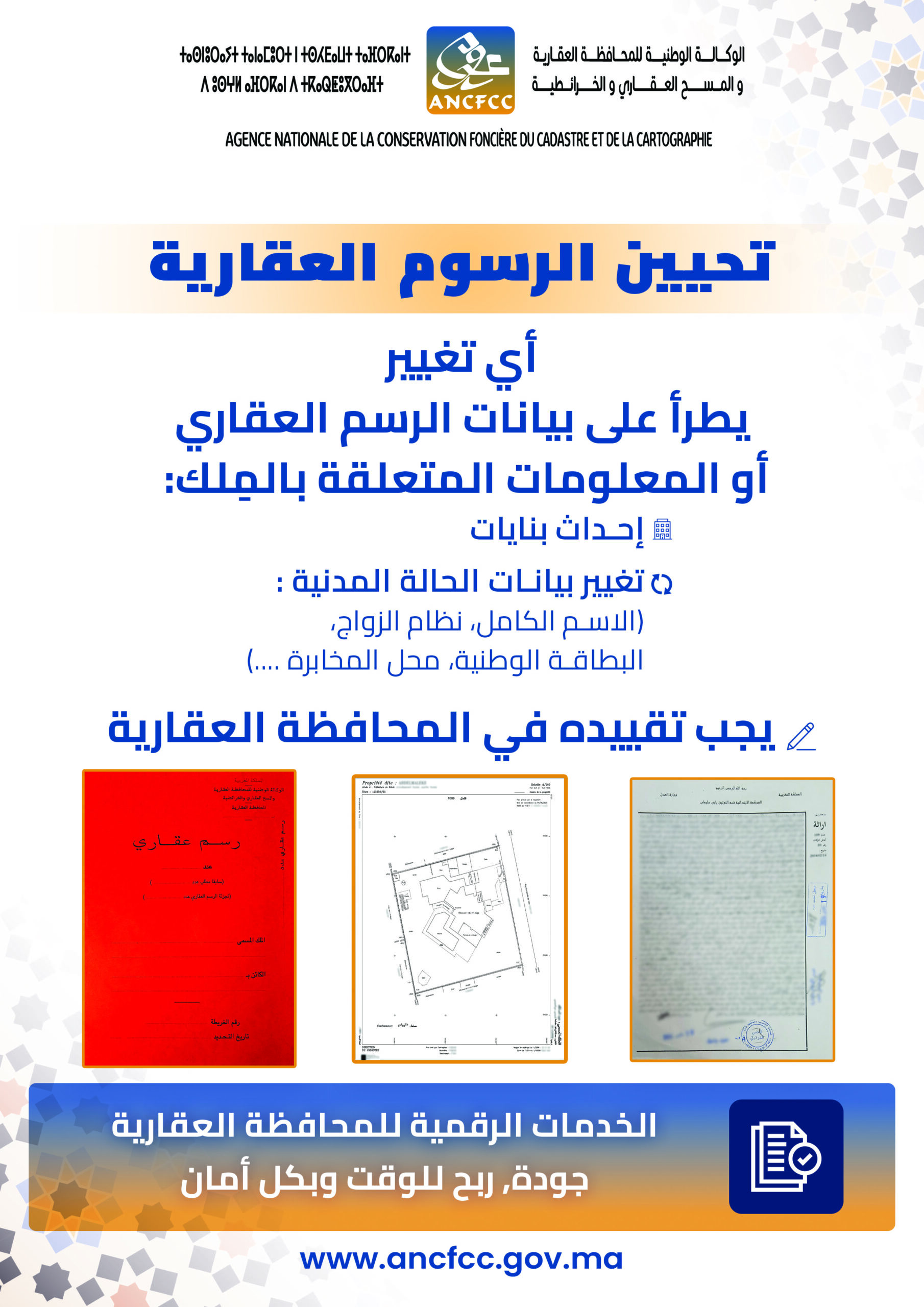قطاع الموانئ بالمغرب من الأفول إلى الانبعاث.. قراءة في المحددات التشريعية والمؤسساتية ورهانات الحكامة

بدر الزاهر الأزرق*
*أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد/ خبير في قانون الموانئ جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء
يُعدّ قطاع الموانئ أحد أبرز المرافق الاستراتيجية التي تعكس مستوى تطور الدولة وقدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي. فالميناء ليس مجرد فضاء لتبادل السلع أو نقطة عبور للبضائع، بل هو مرآة للبنية الاقتصادية، وأداة للتموقع الجيو-استراتيجي، ومدخل رئيسي لتقوية تنافسية البلاد وجاذبيتها للاستثمار.
والمغرب، بحكم موقعه الجغرافي الفريد الممتد على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، كان دائمًا مؤهلًا لأن يجعل من موانئه بوابة للقارات الثلاث، وأرضية لوجستية دولية، غير أن المسار لم يكن دائمًا صاعدًا. فقد مرّ هذا القطاع بمحطات مختلفة تراوحت بين الازدهار في فترات تاريخية معينة، والتراجع الذي كاد يُقصيه من خارطة المبادلات العالمية، قبل أن يشهد في العقدين الأخيرين طفرة نوعية أعادت رسم صورته، وأطلقت دينامية جديدة جعلت منه أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية في مجال البنية التحتية واللوجستيك والتجارة الخارجية.
إن التأمل في مسار الموانئ المغربية يضعنا أمام إشكالية مركزية: كيف انتقل هذا القطاع من مرحلة الأفول التي اتسمت بالهشاشة وضعف القدرة التنافسية، إلى مرحلة الانبعاث التي جعلت من المغرب فاعلًا لوجستيًا بارزًا في الفضاء المتوسطي والإفريقي؟ هذه الإشكالية لا تنفصل عن أسئلة فرعية ترتبط بعوامل التراجع التي عرفها القطاع خلال عقود، خاصة بعد استقلال المملكة ووصولا إلى ثمانينات القرن الماضي، وكطلك ترتبط بالإصلاحات العميقة التي أطلقتها الدولة منذ تلك الفترة لتدارك هذا الوضع، ثم بالرهانات الجيو-اقتصادية الراهنة التي تجعل من الموانئ اليوم أكثر من مجرد منشآت تقنية، لتتحول إلى رافعة للتنمية وأداة للتموقع الاستراتيجي في خضم تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية.
من هذا المنطلق، فإن دراسة قطاع الموانئ المغربي تقتضي استحضار البعد التاريخي الذي يبرز كيف ضاعت فرص كثيرة في السابق، وكيف تراجعت جاذبية الموانئ الوطنية أمام موانئ المتوسط المنافسة، قبل أن تنطلق أوراش كبرى حملت توقيعًا سياسيًا قويًا ورؤية استراتيجية واضحة. كما تستوجب هذه الدراسة الغوص في التحولات البنيوية التي طالت هذا القطاع، سواء على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي، أو على مستوى البنيات التحتية الحديثة المتمثلة أساسًا في ميناء طنجة المتوسط، الذي أعاد رسم الخريطة البحرية والتجارية للمنطقة.
وأخيرًا، فإن هذه الدراسة تفتح النقاش حول الآفاق المستقبلية والرهانات المطروحة، خصوصًا في ظل التنافسية الشرسة التي تفرضها الموانئ العالمية، والتحولات الجارية في الاقتصاد الرقمي والطاقات البديلة والممرات التجارية الجديدة.
الموانئ المغربية في زمن الأفول
عرف قطاع الموانئ المغربي خلال عقود ما بعد الاستقلال مسارًا متذبذبًا عكس في جوانب كثيرة اختيارات تنموية غير متوازنة، وضعفًا في استباق التحولات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فعلى الرغم من المكانة التاريخية لبعض الموانئ مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير، التي لعبت أدوارًا بارزة خلال فترات الحماية وما بعدها، إلا أن العقود الممتدة ما بين الستينيات والتسعينيات القرن الماضي تميزت بتراجع تنافسية هذه الموانئ على أكثر من صعيد، سواء من حيث القدرة الاستيعابية، أو مستوى التجهيزات، أو جودة الخدمات اللوجستية والإدارية. وهو ما انعكس على موقع المغرب في خارطة المبادلات التجارية العالمية، حيث ظل في الغالب مجرد سوق استهلاكية محدودة ومزود أولي بمواد أولية ومنتجات فلاحية وصيد بحري، دون أن يمتلك موانئ قادرة على المنافسة الإقليمية أو جذب التدفقات التجارية الكبرى.
لقد تجلت مظاهر هذا الأفول في عدة مؤشرات. فمن الناحية التقنية، ظلت البنيات التحتية المينائية متقادمة، غير قادرة على استيعاب السفن الحديثة ذات الأحجام الكبيرة، في وقت كانت فيه الموانئ الأوروبية والمتوسطية تعرف ثورة حقيقية في مجال التوسعة والتجهيز. ومن الناحية التدبيرية، كرس التحول من نظام عقود الامتياز وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحتكار الفاعل الحكومي للتدبير والاستغلال معاً، الطابع البيروقراطي لأغلب الموانئ المغربية وأثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المينائية، مما جعل كلفة العبور مرتفعة وزمن المعالجة بطيئًا، وهو ما دفع جزءًا مهمًا من المبادلات المغربية، وخاصة تلك المرتبطة بالمواد المصنعة وشبه المصنعة، إلى المرور عبر موانئ بديلة في إسبانيا والبرتغال. أما على مستوى الرؤية الاستراتيجية، فقد ظل قطاع الموانئ في المغرب خارج الأجندة التنموية الكبرى لعقود، إذ كان يُنظر إليه كمنشآت خدماتية محلية أكثر من كونه رافعة استراتيجية لتسريع النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية.
ومع مرور الزمن، تفاقمت هذه الوضعية لتأخذ بُعدًا بنيويًا، حيث تزايدت الفجوة بين المغرب ومحيطه الإقليمي. فبينما كانت موانئ مثل الجزيرة الخضراء في إسبانيا أو روتردام في هولندا تتطور لتصبح مراكز محورية في سلاسل التوريد العالمية، بقيت الموانئ المغربية محدودة من حيث القدرة على تنويع أنشطتها وعلى استيعاب الحاويات وإعادة توزيعها (أنشطة المسافنة) . هذه الأزمة البنيوية لم تكن مجرد مسألة لوجستية، بل أثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت كلفة التصدير والاستيراد مرتفعة مقارنة بدول منافسة، ما أضعف الجاذبية الاستثمارية وحدّ من قدرة المقاولات المغربية على الولوج السلس إلى الأسواق الخارجية. ونتيجة لذلك، تراجعت مساهمة الموانئ في الناتج الداخلي الخام، وفقد المغرب فرصًا استثمارية وتجارية ثمينة كان يمكن أن تشكل رافعة لتنميته الصناعية والفلاحية.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن قطاع الموانئ في المغرب عاش لعقود حالة من التهميش الاستراتيجي، حيث غابت عنه الرؤية الشمولية المندمجة التي تربط بينه وبين السياسات الصناعية والتجارية والطاقية. ولعل ذلك ما جعل التقارير الوطنية والدولية في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة تُجمع على أن المغرب في حاجة ماسة إلى ثورة مينائية تعيد لهذا القطاع دوره الطبيعي كقاطرة للتنمية وواجهة اقتصادية للبلاد. هذه الوضعية المأزومة كانت بمثابة جرس إنذار دفع الدولة إلى إطلاق إصلاحات جذرية في مطلع الألفية الثالثة، لإعادة هيكلة القطاع على المستويات التشريعية والمؤسساتية والتدبيرية، وهي الإصلاحات التي مهدت لانبثاق جيل جديد من الموانئ، وفي مقدمتها المشروع العملاق ميناء طنجة المتوسط، الذي سيشكل نقطة تحول فارقة في مسار هذا القطاع.
دينامية الانبعاث والتحول الاستراتيجي
إذا كان عقدا السبعينيات والثمانينيات قد رسّخا صورة موانئ مغربية متقادمة وغير قادرة على مجاراة الإيقاع السريع للتحولات العالمية، فإن مطلع الألفية الثالثة دشّن مرحلة جديدة عنوانها البارز الانبعاث والتحول الجذري. فقد أدرك المغرب، في ظل السياق الدولي المتغير، أن رهانات التنافسية الاقتصادية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية لا يمكن أن تتحقق دون ثورة مينائية حقيقية تجعل من البنيات التحتية البحرية قاعدة للتموقع الاستراتيجي. هذا الوعي تجسّد في الإرادة السياسية القوية التي عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ بداية عهده، حيث أعطى دفعة غير مسبوقة للمشاريع المينائية، مؤكّدًا أن الموانئ ليست مجرد مرافق خدمية، بل أدوات سيادية واستراتيجية لتحقيق التنمية والانفتاح الجيو-اقتصادي.
لقد تجلّت هذه الرؤية في إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي شكّل قطيعة مع منطق التدبير التقليدي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الموانئ المغربية. فهذا المشروع، الذي افتتح سنة 2007، لم يكن مجرد ميناء جديد، بل منظومة متكاملة تشمل مناطق حرة صناعية ولوجستية، وبنيات تحتية متطورة لمعالجة الحاويات والبضائع، وارتباطًا مباشرًا بشبكات النقل الطرقي والسككي. كما شكّل أيضًا نقطة تحول على مستوى قواعد تدبير واستغلال قطاع الموانئ بالمغرب، إذ مثل أول تجربة حقيقية لتحرير الخدمات المينائية والعمل وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فقد تم صياغة نصوص قانونية جديدة خاصة بالمركب المينائي، ليتمتع باستقلالية في التدبير عبر إنشاء وكالة طنجة المتوسط، التي أسند إليها الإشراف على الموارد المالية وإدارة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى منحها صلاحيات السلطة العمومية، خاصة فيما يتعلق بنزع الملكية العقارية لأجل المنفعة العامة.
هذه التحولات القانونية والتنظيمية انعكست إيجابًا على قدرة الميناء على استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، العاملين في مجالات المناولة واللوجستيك والخدمات المينائية، عبر عقود امتياز طويلة الأمد تجاوزت ثلاثة عقود. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على حجم التدفقات التجارية الموجهة نحو المركب، وعلى جودة الخدمات المقدمة، مما عزز دوره كأبرز وجهة للمسافنة في المنطقة، وأتاح له جذب مستثمرين كبار في مجالات الصناعات الميكانيكية، لتصبح طنجة المتوسط اليوم أهم ميناء متوسطي في تصدير السيارات.
علاوة على ذلك، وبفضل موقعه الاستراتيجي عند مضيق جبل طارق، أصبح طنجة المتوسط خلال سنوات قليلة من بين أهم الموانئ المتوسطية والعالمية، متفوقًا في حجم معالجة الحاويات على موانئ تاريخية مثل برشلونة ومرسيليا، ومتموقعًا ضمن العشرين الأوائل عالميًا. هذا التحول لم يقتصر على الأرقام والإحصاءات، بل غيّر الصورة الدولية للمغرب، وجعله بوابة لوجستية حقيقية تربط بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا.
إلى جانب طنجة المتوسط، أطلق المغرب إصلاحات عميقة شملت القطاع برمته، بدءًا من سنة 2002 بإصدار قانون 15.02، الذي شكّل مرجعًا تشريعيًا فريدًا على المستوى العالمي، ومهد لتحولات جوهرية في حكامة القطاع. فقد تم تبني مبدأ تحرير الخدمات المينائية وفق مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس الوكالة الوطنية للموانئ لتدبير أكثر من 34 ميناء، مع منحها استقلالية واسعة على مستوى الموارد المالية واتخاذ القرارات، والإشراف على عقود الامتياز التي مكّنت القطاع الخاص من استغلال خدمات محددة. كما تم إنشاء شركة خاصة، “مرسي المغرب”، برأسمال مملوك في أغلبه للدولة، للإسهام في إدارة الخدمات المينائية إلى جانب القطاع الخاص، وتمكنت هذه الشركة من توسيع أنشطتها لتشمل دولًا إفريقية كجيبوتي وبنين، ما يوضح التوجه نحو تعزيز النفوذ الإقليمي عبر الانفتاح على الأسواق الإفريقية.
إضافة إلى ذلك، تم تبني إستراتيجية وطنية للموانئ في أفق 2030، تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكة المينائية على أسس جديدة تجعلها رافعة للتنمية المندمجة. هذه الاستراتيجية شملت بناء موانئ جديدة مثل الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، وتحديث الموانئ القائمة كالدار البيضاء وآسفي والجرف الأصفر، مع إدخال الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية، لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء.
وقد أسهم هذا الانبعاث المينائي في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وتسريع التحول الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر تصنيعا وخلقًا للقيمة وفرص الشغل، كما عزز مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة، دفع العديد من الدول المجاورة، أبرزها إسبانيا، إلى إعادة التفاوض بشأن قواعد التعاون، وإظهار مرونة أكبر في التعامل مع التحولات الاقتصادية المغربية المتسارعة. كما أصبحت الموانئ أداة تأثير ناعمة، حيث مكنت المغرب من التموقع في عدد من الموانئ الإفريقية، وفتحت الباب أمام دول الساحل الإفريقي في إطار المبادرة الأطلسية، من أجل استثمار منصة مركب الداخلة الأطلسي للوصول إلى أهم الطرق التجارية الأطلسية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتمكين هذه الدول من تطوير التجارة وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والهجرة غير النظامية.
إن الانبعاث المينائي المغربي لا يقتصر على الأبعاد التقنية والاقتصادية فحسب، بل يحمل أبعادًا جيو-استراتيجية عميقة. فالمغرب يسعى من خلال تطوير موانئه إلى تعزيز موقعه كفاعل محوري في القارة الإفريقية، مع تكثيف حضوره في غرب إفريقيا، وتوظيف هذه الموانئ كأدوات تفاوض مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين ضمن المبادلات التجارية العابرة للقارات. وإضافة إلى ذلك، تفتح هذه الدينامية آفاقًا واعدة في مجالات الطاقة والرقمنة والابتكار، إذ يجري التفكير في جعل الموانئ المغربية فضاءات متقدمة لاستقبال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودمجها ضمن التحولات البيئية العالمية.
إن تتبع مسار قطاع الموانئ المغربي منذ عقود الاستقلال إلى اليوم يكشف عن تجربة غنية بالتناقضات والدروس. فقد عرف هذا القطاع فترات طويلة من الجمود والتراجع جعلته أقرب إلى عبء على الاقتصاد الوطني منه إلى رافعة تنموية، حيث عانت الموانئ من تقادم بنياتها وضعف طاقتها الاستيعابية، وغياب رؤية استراتيجية تدمجها في المنظومة الاقتصادية الشاملة للبلاد. وهو ما انعكس في تراجع تنافسية المقاولات الوطنية، وارتفاع كلفة المبادلات، وضياع فرص استثمارية وتجارية ثمينة كان بالإمكان أن تضع المغرب في موقع متقدم داخل السلاسل العالمية للتوريد. غير أن التحول الذي عرفته البلاد مع مطلع الألفية الثالثة، بدعم وإرادة سياسية واضحة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعاد رسم صورة الموانئ المغربية وفتح أمامها أفقًا جديدًا، جعلها تنتقل من هامشية إقليمية إلى فاعلية جيو-اقتصادية دولية.
فمشروع طنجة المتوسط، الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ هذا القطاع، لم يكن مجرد بنية تحتية ضخمة، بل مثّل رمزًا لتحول عميق في الرؤية التنموية، حيث باتت الموانئ تُنظر إليها باعتبارها أدوات استراتيجية للتموقع العالمي، ومفاتيح لتقوية السيادة الاقتصادية، ومجالات استثمارية قادرة على استقطاب الرساميل الكبرى، وتحفيز بروز مناطق صناعية ولوجستية جديدة. إن هذا الانبعاث لم يتوقف عند حدود طنجة المتوسط، بل امتد إلى مشاريع أخرى قيد الإنجاز كالناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، وإلى إصلاحات هيكلية مست الإطار القانوني والمؤسساتي والتدبيري. وهو ما يجعل اليوم من قطاع الموانئ إحدى الرافعات الأساسية لتنزيل الاستراتيجيات الكبرى للمغرب، سواء في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، أو في مجال تعزيز الشراكات جنوب-جنوب مع إفريقيا، أو في مجال التفاوض مع القوى الاقتصادية الكبرى.
لكن هذا المسار الإيجابي لا ينبغي أن يُغطي على التحديات العديدة التي ما تزال مطروحة. فالموانئ المغربية، رغم تطورها اللافت، تظل مطالبة بتعزيز تنافسيتها على أكثر من مستوى. فهناك أولًا تحدي الاستدامة المالية، إذ يتطلب تطوير الموانئ استثمارات متواصلة وضخمة في التجهيز والتوسعة والرقمنة، وهو ما يفرض البحث عن صيغ مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهناك ثانيًا تحدي الاندماج الترابي، حيث لا يمكن للموانئ أن تحقق كامل مردوديتها دون ربطها بشبكات نقل داخلية قوية تشمل السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات، ودون ضمان تكامل وظيفي بين مختلف الموانئ لتفادي التكرار أو المنافسة الداخلية غير المجدية. ثم هناك ثالثًا تحدي التأهيل البشري، إذ أن نجاح التحول المينائي رهين بوجود كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية التي يعرفها قطاع النقل البحري واللوجستيك عالميًا.
إلى جانب هذه التحديات الداخلية، يواجه المغرب تحديات جيو-استراتيجية خارجية لا تقل أهمية. فالتنافسية في البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا تعرف تصاعدًا ملحوظًا، مع بروز مشاريع مينائية ضخمة في دول الجوار، ومع سعي قوى اقتصادية كبرى لإعادة رسم طرق التجارة العالمية عبر مبادرات مثل “الحزام والطريق”. وفي ظل هذه التحولات، سيكون على المغرب أن يحافظ على جاذبية موانئه عبر تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية، وبناء شراكات دولية مرنة، واستباق التغيرات المرتبطة بالانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
وعليه، فإن مستقبل قطاع الموانئ المغربي مرهون بقدرته على الجمع بين ثلاثة مستويات من الفعل: أولا، الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة لضمان موقع تنافسي عالمي؛ ثانيًا، تعزيز التكامل بين الموانئ وباقي القطاعات الاقتصادية الوطنية بما يخلق دينامية تنموية متوازنة على المستوى الترابي؛ وثالثًا، الارتقاء بالموانئ إلى مستوى فاعل جيو-اقتصادي قادر على التكيف مع التحولات العالمية، والمساهمة في تعزيز مكانة المغرب كجسر بين الشمال والجنوب.
إن الخلاصة الكبرى هي أن الموانئ لم تعد مجرد فضاءات مادية لعبور السلع والبضائع، بل أضحت فضاءات استراتيجية تختزل رهانات الاقتصاد والسيادة والتنمية والتموقع الدولي. ومن ثمة، فإن مسارها في المغرب من الأفول إلى الانبعاث ليس سوى بداية مرحلة جديدة سيكون على الفاعلين العموميين والخواص، وعلى النخب الاقتصادية والسياسية، أن يواصلوا استثمارها بحكمة وبعد نظر. فالرهان اليوم لم يعد يقتصر على امتلاك موانئ حديثة، بل على جعلها محركات فعلية لتحول اقتصادي شامل، وضمان أن يظل المغرب في موقع متقدم ضمن خريطة المبادلات العالمية، وفي قلب دينامية التكامل الإفريقي-الأوروبي-الأطلسي التي ترسم ملامح القرن الحادي والعشرين.