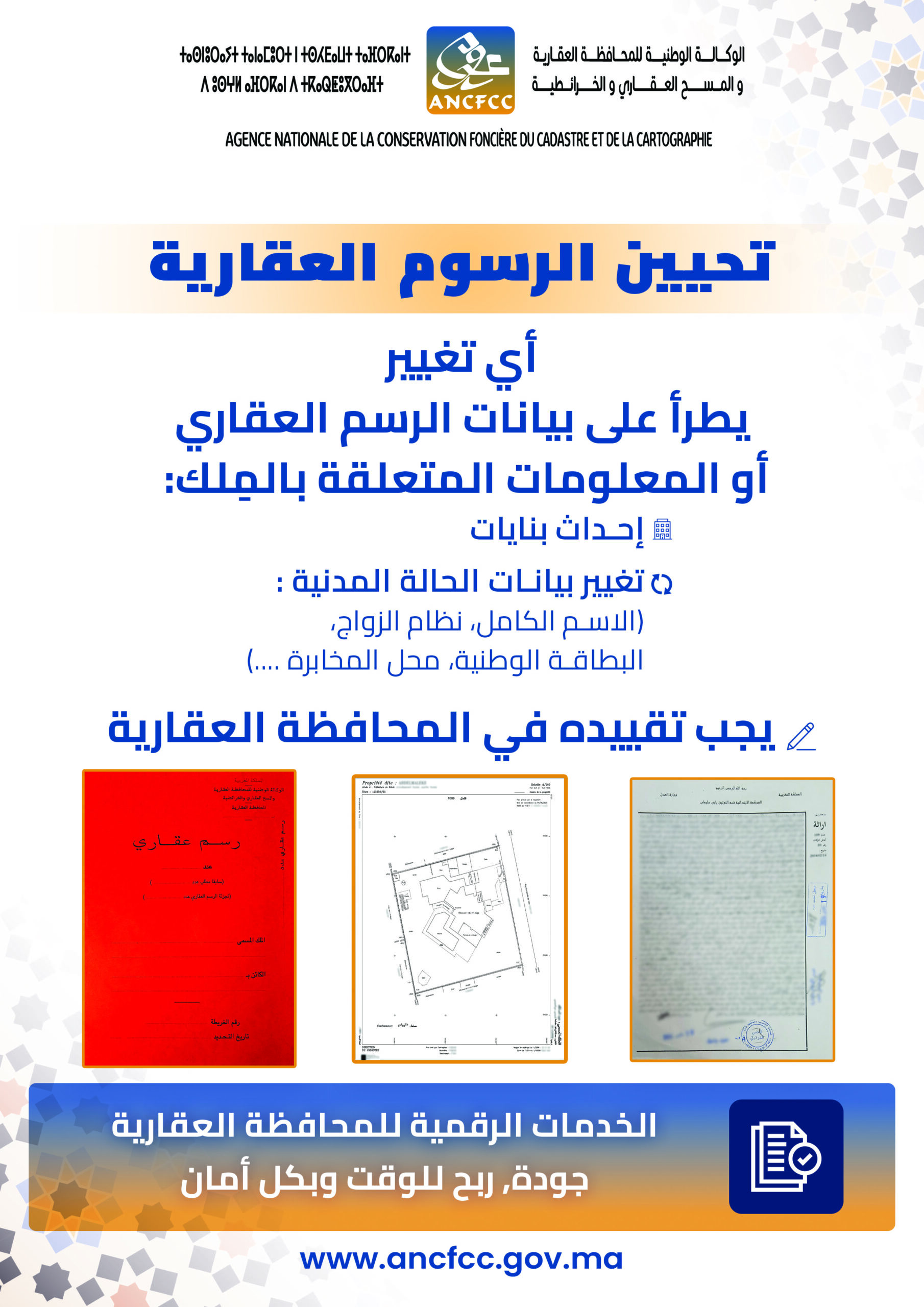غير منتسب.. غير مؤثّر؟ هكذا يقيد النظام الداخلي أجنحة البرلماني المستقل

حسين العياشي
أحسنَ المُشرّع حين فتح باب الاستقلالية للشباب كي يخوضوا غمار الانتخابات بصفةٍ مستقلة مع تغطيةٍ لجزءٍ من تكاليف حملاتهم. لكنّ حادثةَ منع نائبةٍ غير منتسبة من المشاركة في أشغال لجنة المالية أثناء مناقشة قانون مالية 2026 كشفت، بوضوح جارح، أنّ شرعية الصندوق لا تكفي وحدها لانتزاع موطئ قدمٍ داخل “مطبخ” القرار البرلماني. فبمجرد أن يعبر “المستقل” بوابة البرلمان، يتحوّل عملياً إلى ” نائب غير منتسب” ما لم ينخرط في فريقٍ أو مجموعة، ومع هذا التحوّل تتبدّل مفاتيح التأثير: التنظيم قبل الصوت، والتمثيل قبل الخطابة.
داخل اللجان—مطبخ التشريع الحقيقي—يُنصّ صراحةً على أنّ لكل نائب غير عضو حقَّ الحضور والمداخلة من دون أن يشارك في التصويت! (المادة 63). عبارةٌ قصيرة، لكنها تحسم ميزان القوة: تستطيع أن تُسمِع حجّتك، لكنك لا تُضيف رقماً ساعة الحسم. وحتى الجلوسُ على مقاعد اللجان بالنسبة لغير المنتسبين لا يتم بقرار فردي، بل بقرارٍ من مكتب المجلس وفي حدود العدد المقرر (المادة 60). أي إن الوصول إلى “المطبخ” نفسه مشروط بمفتاحٍ تنظيمي، لا بمجرد الرغبة أو وجاهة الحجة.
ثمّة بابٌ آخرُ للإقصاء الهادئ: الزمن! فـندوة الرؤساء —التي تحدد برمجة الأشغال وتوزيع الأوقات— لا تضمّ غير المنتسبين في تركيبتها، فيما تُمنح لرؤساء الفرق والمجموعات داخلها أوزانٌ تصويتيةٌ تُعادِل عدد أعضاء هيئاتهم (المواد 84–86). أي عملياً: من لا هيئة له، لا يملك ساعة النقاش. ويبلغ هذا المبدأ ذروته في قانون المالية، حيث تُحصر المناقشة ضمن حصصٍ زمنية إجمالية موزّعة بين الفرق والمجموعات و”النواب غير المنتسبين” (المادة 226). عند تقديم التعديلات في الجلسة العامة، يُخصَّص لهؤلاء “غلافٌ زمني” مشترك تستحود عليه الأغلبية التمثيلية؛ فإذا نُفِد الوقت، تُدرج التعديلات للتصويت بعد رأي الحكومة من دون تقديم شفهي. هكذا يتحوّل الصوت الفردي إلى هامشٍ داخل هامش.
حتى في الرقابة السياسية الكبرى— من الجلسات الشهرية مع رئيس الحكومة إلى آليات الأسئلة —يسير الإيقاع على قاعدة التمثيل النسبي، مع “مراعاة حقوق غير المنتسبين” التي تُثبت الحضور أكثر مما تزيد الأثر (على سبيل المثال: المواد 281–284). المعنى البسيط خلف الصياغة المهذبة: الزمن يوزَّع وفق الأوزان التنظيمية لا وفق حاجات الحجّة. فما الحل؟
لعلّ التجربة المغربية نفسها قدّمت الدرس مبكّراً: بعد انتخابات 1977، لم ينتظر عددٌ وازنٌ من النواب المستقلين “اعترافاً” بوزنهم الفردي؛ بل انتقلوا سريعاً من استقلالية الصفة إلى تنظيم الكتلة، فأسّسوا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أحمد عصمان. لم يذهبوا إلى “فريق المستقلين” داخل البرلمان، بل إلى إطارٍ حزبي منحهم فريقاً نيابياً وموقعاً تفاوضياً كاملاً داخل الأجهزة. تلك الواقعة ليست حنيناً إلى الماضي بقدر ما هي وصفةٌ سياسية: من أراد تأثيراً مؤسسياً، فعليه أن يحمل مفاتيح الهيكل التنظيمي.
من هنا تبدو واقعةُ 2026 منطقيةً لا شاذّة. النظام الداخلي صريح: حضورٌ ومداخلةٌ بلا تصويت في اللجان لغير الأعضاء (المادة 63)، تموضعٌ داخل اللجان بقرار المكتب وفي حدود المقاعد (المادة 60)، برمجةٌ وزمنٌ تصنعهما ندوةٌ لا تمثيل فيها لغير المنتسبين (المواد 84–86)، وحصصٌ مشتركةٌ في قانون المالية تُذيب الصوت الفردي في “غلافٍ زمني” عام (المادة 226).
إذن، كيف لا يتحوّل دعمُ الاستقلالية الانتخابية إلى هشاشةٍ مؤسسية؟ الطريقان واضحان: إمّا أن يتكتّل غير المنتسبين لتأسيس مجموعةٍ أو فريق متى بلغوا النصاب واستوفَوا المساطر والآجال، فيحصلون على مقعدٍ وصوتٍ داخل مفاصل القرار؛ وإمّا أن يُعاد ضبط توزيع الزمن والإجراءات بما يضمن حدّاً أدنى فعّالاً—لا شكلياً—لمشاركتهم، خصوصاً في قانون المالية حيث تُختبر أولويات الدولة. ما عدا ذلك، ستظلّ الاستقلالية شعارَ دخولٍ لامعاً.. وصوتاً منخفضاً تحت قبّةٍ لا تسمع إلّا من يتكلم بلغة التنظيم الأغلبي التمثيلي.